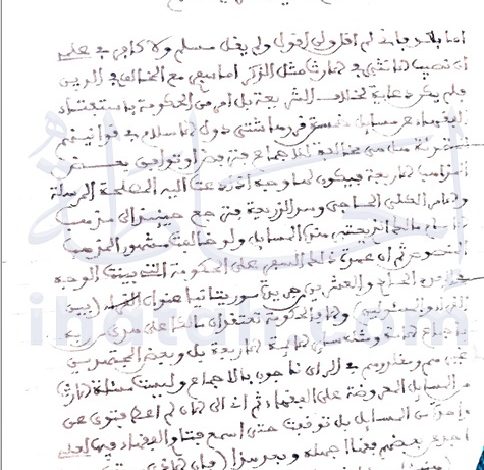
عَدَّ أكثر العلماء الموريتانيين الدولةَ الموريتانية الناشئة امتدادا لدولة المستعمِر، أو هكذا دَلَّ تعاملهم معها على الأقل؛ إِذ اعتزلوها، و”فَرُّوا بدينهم منها”، وحَثُّوا مَن حولهم على الابتعاد عنها.
ولذا نشأت الدولة الوليدة في “غنى عنهم”، فَاسْتَمَدَّتْ دستورها وقوانينها من الدستور والقانون الفرنسي، وانتظمت مدنيتُها وعمرانها على النَّمَط الغربي تقريبا.
ورغم أن الفقهاء تداركوا القوانين أو بعضَها في وقت لاحق؛ إلا أن العقل الفقهي بقي عاجزا عن استيعاب كثير من قضايا ومفاهيم الدولة الحديثة، فلم يستطع كثيرٌ منهم وَضْعَهَا في الخانة المناسبة لها من الأحكام الشرعية، كما هو الشأن في الانتخابات، ومعضلة الرق، ودفع الضرائب.
بل إن بعضَ أَمَاثِلِهِمْ قرأ نَصَّ الدستور الموريتاني فلم يفهم منه حرفا، رغم أنه كُتِبَ بلسان عربي مبين!
وربما كانت الجرأة التي نشهدها اليوم على المال العام، وتكييف بعض الرشاوى التي يبذلها المسؤولون على أنها “عطايا سلطانية”، من نتائج الفهم القديم لطبيعة الدولة.
ليست “الغفلة”، التي جعلها المحدِّثُون والفقهاءُ سببا لِرَدِّ حديثِ الْمُتَّصِف بها ومَنْعِ إِفْتَائِهِ، سوى الجهل بواقع الناس وأحوالهم وطبائعهم، وما يعتري ذلك من تغير.. ولك، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أن تُقَدِّرَ الخطر الماحق الذي يمكن أن يتسبب فيه – مِنْ حيث لا يشعر – مَن اتَّصَفَ بذلك.
لقد نَفَذَتِ الشيوعية إلى كثير من الفئات الضعيفة، التي لا تفهم أُسُسَهَا الفكرية، من باب وقوف رجال الدين إلى جانب الظَّلَمَةِ، وتَمَالُئِهِمْ على الظلم أو سكوتهم عنه.. والحديثُ عن وجوب احترام العالم في هذه الحالة حديثٌ مُسْتَفِزّ، لِأَنَّ وجوبَ احترامه إنما هو لأجل احترام الدين الذي يمثله والعلم الذي يحمله، ومن “شروط التَّكْمِلَةِ أن لا تعود على أصلها بالإبطال” كما قال الشاطبي.
لم تستطع كتابات مفكري “الإسلام السياسي” أن تَسُدَّ الفراغَ الذي نعانيه في ميدان فكر الدولة وثقافتها، لسببين: أولهما أن هؤلاء الكَتَبَة لا يتمتعون بالاتفاق والاجتماع الذي كان يتمتع به علماؤنا لحظة ميلاد الدولة، والثاني أن ما كتبوه مبتوتَ الصِّلَةِ بمنظومتنا الفقهية التقليدية، وهي بالمناسبة منظومة ثرية مثيرة للإعجاب.
ومن المؤسف أن تراثَنا الفقهي لم يَنَلْ من الاستنطاق والقراءة والبحث ما ناله الشعر والأدب، أيامَ نشأة المؤسسات الجامعية، وهي أيامُ ازدهار البحث العلمي في البلد، وقد انضاف إلى هذا التقصيرِ تقصيرُنا في إبراز دور العلماء في الدفاع عن الفئات المستضعفة، وبَذْلِ جاههم ومَالِهِمْ في افْتِكَاكِهَا من أيدي الظَّلَمَةِ، وتقصيرُنا في توضيح التراث الفقهي المتعلق بالرق؛ فأفسحنا بذلك المجالَ للفهم الخاطئ له، ولمحاكمته – تبعا لذلك – إلى سِيَاقٍ غير سياقه وزَمَنٍ يختلف عن زمنه.






